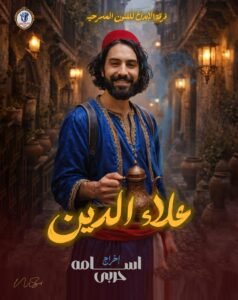الفندق: مسرح الوعي المعلّق بين الحياة والموت
بقلم: مـحمد فاضل القباني
يُعدّ نص فندق العالمين للكاتب الفرنسي إيريك إيمانويل شميت أحد أبرز النصوص المسرحية التي قاربت موضوع “البرزخ الوجودي” من زاوية فلسفية تأملية، بعيدًا عن الخطابات الماورائية التقليدية أو الصور النمطية للموت والحياة الأخرى. فمن خلال فضاء خيالي يقع خارج الزمن المألوف، وأحداث تدور في فندق يضم نزلاء في غيبوبة، تتأسس بنية درامية تسائل الإرادة، والمصير، والندم، والتحول. فالنص ينتمي إلى ما يمكن تسميته بـ”مسرح الاحتمال الفلسفي”، إذ لا يقدم وقائع مغلقة، بل يوسّع أفق التخيل على قاعدة: “ماذا لو مُنحت للإنسان لحظة أخيرة من الإدراك بعد أن قرر الرحيل؟
بنية النص ومفهوم البرزخ الدرامي
ينطلق النص من منطق الهُوية المُعلّقة. الشخصيات، الوافدة إلى “الفندق”، لا تدرك تمامًا إن كانت قد ماتت بالفعل، أم أنها تعيش لحظة أخيرة من الوعي. هذا التردد بين حالتين – الحياة والموت – يؤسس لما يمكن تسميته بـ”الزمن الدرامي الرمادي”، زمن غير خطي، غير محكوم بالتسلسل، بل بالتأمل. وهنا تتجلّى مهارة شميت في بناء شخصيات تكتشف ذاتها تدريجيًا، من خلال الحوار الداخلي والتقاطع مع شخصيات أخرى، دون الحاجة إلى ذروات درامية صاخبة. المفارقة أن كل شخصية تعيد صياغة ماضيها بتجرد، حيث لا مجال للكذب أو الأقنعة، فالحياة الماضية تُستعرض في منطقة تقع خارج نظام العقاب والثواب، لكنها مشبعة بالندم، والحيرة، والحاجة للغفران من الذات قبل الآخرين.
المعالجة الدرامية لفادي نشأت
لجأ الدراماتورج فادي نشأت إلى قراءة النص ليس بوصفه نصًا مغلقًا، بل بوصفه “هيكلًا مفتوحًا على إعادة التأويل”. ولذلك، جاءت معالجته محمّلة بعدة قرارات درامية لافتة. أولها: إدماج شخصية “أوسكار” المستلهمة من مسرحية أوسكار والسيدة الوردية لشميث نفسه، في نسيج العرض. هذا القرار يمنح العمل بعدًا ميتافيزيقيًا إنسانيًا مضاعفًا، حيث يتحوّل “أوسكار” إلى مرآة إضافية لفكرة العيش على الحافة، طفل يحتضر، يكتب إلى الله، يحاور الموت بطريقة طفولية صافية، ليعيد المتلقي إلى سؤال الإيمان والبراءة والفقد.
كما قام نشأت بإعادة توزيع التوترات داخل النص، فجعل من بعض الشخصيات مراكز طاقة درامية مستقلة (مثل الشاب المستهتر، ولاعبة الحبل، والمنجم)، محولًا العرض من “تتابع اعترافات” إلى “شبكة حوارات متقاطعة”، حيث كل قصة تضيء الأخرى، دون أن تتفوق إحداها على البقية. واللافت أن النص في هذه المعالجة لا يُقدَّم كخطبة عن الانتحار أو الغيبوبة، بل كحالة إنسانية تتسرب إلينا بتكثيف وشعرية هادئة.
اللغة والدرامية الباطنية
احتفظت المعالجة بروح النص الأصلي، الذي يُراهن على اللغة كمجال للاعتراف، والبوح، والمواجهة. فهي لغة ذات وظيفة درامية داخلية، تتقدم من الخارج إلى الداخل، حيث يتقاطع ما يُقال مع ما يُفكَّر فيه. وقد نجحت المعالجة في الحفاظ على هذا العمق، مع تبسيط ضروري يتوافق مع جمهور مسرح الشباب، دون الإخلال بالعمق الفلسفي للنص.
بالمجمل، فإن الدراماتورج هنا لم يقدّم النص كمجرد “مادة قابلة للعرض”، بل تعامل معه كبنية ذهنية تتطلب تفكيكًا وإعادة تشييد، فكان التأويل جسرًا بين فلسفة شميت الأصلية، وتجربة المتلقي المصري المعاصر، بكل ما تحمله من هشاشة نفسية، وميل للمصالحة الذاتية، وشغف بإعادة المعنى في زمن الحيرة.
الرؤية الإخراجية والسينوغرافيا
يستند العرض المسرحي الفندق، في جوهره، إلى فضاء غير واقعي، شبه متخيّل، لا يطمح إلى تجسيد العالم كما هو، بل كما قد يكون في لحظة ما قبل النهاية أو لحظة ما بعد القرار. هذا النوع من النصوص لا يُمكن التعامل معه بمنطق الإخراج التقليدي، لأن الزمن فيه ليس زمنيًا خطيًا، والمكان ليس مكانًا ماديًا يمكن التعرف عليه، بل هو استعارة كبرى لـ”البرزخ”، أي المنطقة الحدّية بين الحياة والموت، بين القرار واللاشعور، بين التوبة والانطفاء. من هنا، تأتي أهمية الرؤية الإخراجية التي تبنّاها المخرج محمد الطايع، والتي أعلت من البُعد الرمزي والبصري، وقدّمت المكان المسرحي باعتباره معادلًا دراميًا لحالة “الوعي المعلّق”. حيث اعتمدت الرؤية الإخراجية على تشكيل فراغ بصري متقشّف، لكنه عميق الدلالة. الديكور الذي صممه محمد فتحي جاء قائمًا على اللون الأبيض، لا بصفته لونًا محايدًا فحسب، بل بصفته مساحة تُتيح لما عداه أن يُقال، أن يُلمَس، أن يُحسّ. الأبيض هنا ليس لونًا بريئًا، بل لونًا فلسفيًا، يقع على الحافة بين النور والفراغ، بين العدم والانبعاث.
تم توزيع عناصر المكان المسرحي بوعي معماري دقيق؛ على الجانبين غرف تشبه غرف الفنادق أو غرف العناية المركزة، وفي العمق مصعد يتكرر ظهوره كأداة انتقال، وليس مجرد وسيلة نقل. والمصعد هنا ليس تفصيلة واقعية، بل رمزًا حاسمًا في البنية البصرية: هل الصعود يعني الموت؟ هل الهبوط يعني العودة للحياة؟ أم أن المصعد نفسه خدعة مسرحية لتأخير القرار؟
وقد أُدخلت تقنيات الفيديو مابينج (من تصميم محمد المأموني) لتفعيل وظيفة المصعد، ولترسيخ وهم المكان العابر. خلف مكتب الاستقبال، نجد جداريات لساعات بلا عقارب، في إشارة رمزية إلى “زمن مُعلّق”، أو غياب الزمن كشرط للوعي. هذا التصميم يحاكي تمامًا طبيعة النص، ويحوّل الخشبة إلى موقع للانفصال عن الواقع.
الإضاءة والدراما الصامتة
تُعدّ الإضاءة، التي صممها الطايع نفسه، أحد الأعمدة البصرية الأكثر حساسية في العرض. فقد استخدم مستويات مختلفة من الضوء الأبيض، المائل أحيانًا للزرقة أو الرمادية، لتوليد انفعالات صامتة داخل المشهد. الإضاءة لا تكتفي بكشف الممثلين، بل تُمارس وظيفة درامية قائمة على التوقيت والتدرج: فمع كل اقتراب من “لحظة المصير”، تزداد الإضاءة سطوعًا أو تنسحب تدريجيًا، بما يحاكي حالة التوتر الداخلي.
كما تم استخدام الضوء الخلفي لعزل الشخصيات في لحظات المواجهة أو البوح، وكأن كل شخصية تعود إلى داخلها لتواجه ذاتها بعيدًا عن “ضوء الجماعة”. وهنا، نلمس وعيًا إخراجيًا بأن “الضوء” ليس أداة كشف فني فقط، بل أداة كشف وجودي.
حركة الممثلين من التكوين الخارجي إلى الداخل
اعتمد الطايع على حركة جسدية مقتصدة ومدروسة، تميل إلى الاقتصاد الحركي لا التهويل، ليظل تركيز الجمهور على ما يُقال ويُفكّر فيه، لا على ما يُمثّل أو يُستعرض. تم توجيه الممثلين لاستخدام الجسد بوصفه “ظلًا داخليًا”، لا آلة إظهار. فالحركة على الخشبة كانت محسوبة بدقة، مع تركيز على لحظات الوقوف والسكون، بما يعزز فكرة الزمن المُعلّق.
تكوينات الممثلين جاءت في تناغم واضح مع توزيع الديكور والإضاءة؛ شخصيات تتحرك ضمن إحداثيات محددة تُحاكي دائرة مغلقة، أو خطوط متقاطعة، تعكس حالتهم النفسية، وكأنهم داخل متاهة ذهنية. التقاء الشخصيات حول المصعد، أو تكرار جلوسهم في مناطق ثابتة، منح العرض سمة طقسية، كرّست طابع “المسرح التأملي”.
العناصر الجمالية من الحياد البصري إلى الكثافة الرمزية
تميزت ملابس العرض (تصميم: سماح سليم) بانسجامها مع المنظومة البصرية العامة؛ تعكس هوية كل شخصية ومستواها الاجتماعي وعملهم في عالم كل منهم.
أما الموسيقى والأغاني، فقد أضفت بُعدًا وجدانيًا على الإيقاع المسرحي، دون أن تُشوّش على التجربة البصرية أو تفرض نفسها. أشعار سامح عثمان وألحان زياد هجرس تداخلت بلطف في النسيج الدرامي، لتمنح لحظات البوح امتدادًا سمعيًّا يُضاعف أثرها.
تحليل الأداء التمثيلي وتعدد مستويات التمثيل
تنوّعت الشخصيات في العرض ما بين لاعبة السيرك، الشاب المستهتر، الخادمة، المنجّم، المديرة، والطبيبة… وكلها شخصيات تشارك في خاصية واحدة: أنها تقف على الحد الفاصل بين وعي قديم وآخر يتشكل في اللحظة المسرحية. وقد أجاد الممثلون التعبير عن هذه الحالة من خلال أداء قائم على التحول الداخلي الهادئ، حيث تبدأ الشخصية بوعي مشوّش أو دفاعي، ثم تنكشف تدريجيًا أمام نفسها والجمهور.
الاقتصاد الحركي والانفعال الداخلي
تميّزت لغة الجسد في العرض كله بالتقشف والتعبير الرمزي. لا مبالغات، لا تصادمات جسدية عنيفة، بل تمهل محسوب، يعبّر عن قلق داخلي أكثر مما يعبر عن أحداث خارجية. وقد جاءت معظم الانفعالات عبر تغيّر الوتيرة الإيقاعية للحركة، أو تموضع الشخصية في الفراغ، أو حتى بالجلوس أو الثبات الطويل، مما أضفى على المشاهد نوعًا من الصمت المُضمر، كأن الممثل يُحاور نفسه لا الجمهور.
في كثير من المشاهد، كانت الشخصيات تتحرك داخل ما يشبه “الدوائر المغلقة”، ما عزز الإحساس بأنها عالقة في تكرار وجودي. في المقابل، حين تتحقق لحظة الإدراك أو الاعتراف، كان الجسد يخرج من هذه الدائرة، ويتقدم نحو المصعد أو يلتفت إلى شخصية أخرى، في إشارة إلى تغيّر داخلي حقيقي.
الصوت والانفعالات الدقيقة
الصوت في هذا العرض لم يكن وسيلة خطابية، بل أداة تفكيك للذات. اعتمد الممثلون على التحكم الدقيق في طبقات الصوت، فانتقلوا بسلاسة من النبرة المستقرة إلى الارتباك، ومن الجملة المستوية إلى التلعثم أو التردد، بما يعكس التحول النفسي الداخلي دون الحاجة إلى تعبيرات مفرطة.
اللافت أن العرض تجنّب الصراخ والانفعالات الصاخبة، واختار بديلًا عنها الحوارات المنخفضة، والصمت الطويل، والمواجهات البطيئة. هذا الأسلوب ساعد في إبراز التوتر الداخلي كمحور أساسي في الأداء.
التمثيل الجماعي: من البطولة الفردية إلى طقس الاعتراف
رغم وجود شخصيات مركزية، لم يعتمد العرض على “بطولة منفردة”، بل جاء الأداء جماعيًا بامتياز. كل شخصية كانت تحتاج الأخرى لتكتمل. وهكذا، كانت الحوارات أشبه بمرآة مزدوجة، كل جملة تُقال تكشف عن شيء في المتكلم كما في المستمع. هذا الشكل التفاعلي في الأداء عزز من الإحساس بأننا أمام “طقس اعتراف جماعي”، لا مجرد قصص منفصلة.
الدلالات الفلسفية والرمزية:
الغيبوبة: استعارة لمرحلة “ما قبل الاعتراف”
الغيبوبة هنا ليست حالة مرضية فقط، بل رمز لحالة الوعي المشوّش التي نعيشها – ونتجنّب مواجهتها – أثناء حياتنا اليومية. الشخصيات التي تدخل الفندق لا تكون مدركة تمامًا لما تمر به، بل تخوض حالة من التيه المحسوب، حيث تنكشف تدريجيًا طبقات الذات. هذا التدرج هو ما يجعل المسرحية أقرب إلى الطقس التطهيري منه إلى العرض الحكائي؛ الغيبوبة تتحول إلى أداة للكشف الذاتي، والاعترافات تأتي لا بوصفها نهاية درامية، بل بوصفها بداية تحرر داخلي.
المصعد: رمز القرار أم آلية قدرية؟
من أبرز الرموز التي وظفها العرض هو “المصعد”، الذي يحدّد مصير كل شخصية: إما صعودًا نحو الموت، أو هبوطًا نحو الحياة. لكن الطرح الإخراجي لم يكن حاسمًا في دلالة المصعد، بل تعمّد الإبقاء عليه ككائن رمزي مفتوح. في بعض المشاهد، يبدو المصعد أشبه بمحكمة عليا – لا يُرى قضاتها – تقرر دون شفافية. وفي مشاهد أخرى، يبدو وكأنه مرآة تعكس القرار الداخلي للشخصية، أي أنه لا يقرّر، بل يُنفّذ ما تقرره الروح.
سؤال الإيمان: من الإنكار إلى الاحتمال
واحدة من أقوى التحولات الرمزية في العرض، تمثلت في رحلة الشاب “جوليان” من الاستهزاء بكل ما هو ميتافيزيقي، إلى لحظة التردّد أمام السؤال: “هل هناك إله؟” ليُجيب: “ربما”. هذه الـ “ربما” ليست مجرد كلمة، بل اختزال لحيرة جيل بأكمله، فقد الثقة بالخطابات الدينية الجاهزة، ولم يعد يملك اليقين، لكنه لا يملك أيضًا الإنكار المطلق.
الإيمان هنا لا يُقدَّم بوصفه نهاية مطمئنة، بل كمجهود نفسي شاق، يبدأ من الاعتراف بعدم المعرفة، ويمر بالحب، وينتهي بالاحتمال. ويبدو أن شخصية جوليان قد كُتبت (أو أُعيد تأويلها) لتكون أقرب إلى تجربة الكاتب نفسه – شميت – الذي عاش تحولًا مشابهًا، من الإلحاد إلى الإيمان “اللايقيني” بعد تجربة وجودية قاسية في الصحراء الجزائرية.
الطفولة كحالة يقين مؤجل: “أوسكار” بوصفه بوصلة رمزية
إدخال شخصية “أوسكار”، الطفل المصاب بالسرطان، شكل إضافة رمزية غنية. فالطفولة هنا ليست مجرد مرحلة عمرية، بل حالة وجودية عالية الصفاء، يعبّر فيها الإنسان عن أقسى الأسئلة بأبسط العبارات. أوسكار لا يناقش فكرة الموت، بل يعيشها، ويكتب عنها، ويحاورها، وكأنه أكثر وعيًا من البالغين.
وجوده في العرض يخلق توازنًا بين عمق الأسئلة وبراءة الطرح، ويجعل من الطفل بوصلة رمزية تشير دائمًا إلى أن الحقيقة لا تُقال بصوت عالٍ، بل تُشعَر، وأن الإيمان لا يُثبت بالحجج، بل يُختبر بالحضور.
المعنى كعملية ذاتية لا تُفرض
واحدة من أبرز إنجازات هذا العرض أنه لا يفرض معنى واحدًا، بل يترك لكل مشاهد أن يخوض تجربته الخاصة. كل شخصية في العرض تمثّل نمطًا حياتيًا متكررًا في المجتمع: الفنانة التي ضحّت بحياتها من أجل المجد، الأب الذي غاب عن ابنته، الممرضة التي أخطأت، المريض الذي شكّك في كل شيء… وهكذا يصبح العرض مرآة متنوعة لتجربة بشرية جامعة، تسمح لكل متفرج أن يرى نفسه في إحدى الزوايا.
وبدلًا من تقديم خطبة وعظية عن المصير، فإن العرض ينسج شبكة من الرموز والتساؤلات تظل مفتوحة حتى بعد انتهاء العرض، وهذا هو جوهر المسرح الفلسفي المعاصر: المسرح الذي لا يُطمئن، بل يُنبه.
الخاتمة
الرؤية الإخراجية لمحمد الطايع لم تقع في فخ التجميل البصري، بل صنعت من البساطة أداة تأثير، ومن الفراغ أداة امتلاء. كذلك جاءت المعالجة الدراماتورجية لفادي نشأت متوازنة، وواعية بفخاخ النقل الحرفي، فاختارت التأويل لا الترجمة، والإضافة لا التبعية. أما أداء الممثلين، فقد تميز بانضباط فكري ووجداني، يعكس تدريبًا أكاديميًا وانخراطًا حقيقيًا في التجربة.
نجح العرض في تحويل المسرح إلى حالة وجدانية وفكرية، لا تنتهي عند آخر مشهد، بل تظل تُراود المتفرج بأسئلتها العالقة. وحين يحدث ذلك – أي حين يمتد العرض إلى ما بعد الخشبة – نكون أمام تجربة مسرحية جديرة بالاحتفاء والنقد والتأمل.