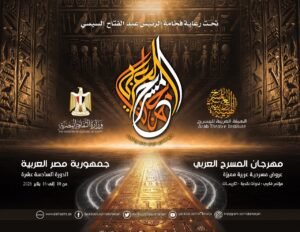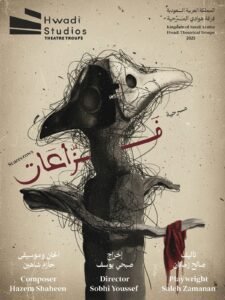أحمد عبد الرازق أبو العلا: يكتب عن مسرح السامر وعبد الرحمن الشافعي

احمد عبد الرازق ابو العلا
لأن المسرح -بطبيعته- فن جماهيري، يستطيع تحقيق وجوده الفعلي بالتحامه مع الناس ، محققا رغبتهم العارمة في الاستمتاع بالفرجة، من هنا تكون الجماعية عاملا من العوامل المُساعدة في إحداث المُتعة المؤثرة في الوجدان، خاصة حين تكون رسالته قادرة على احتضان همومهم اليومية، وقادرة على التعبير عن قيم الحق والخير والجمال ..
وتأتي العروض المسرحية الشعبية، في مقدمة الأشكال التي تستطيع تحقيق الأهداف المُشار إليها لاستنادها وتوظيفها لعدد من عناصر الفرجة، التي تربى عليها الناس، وأثرت في نفوسهم، تلك العناصر تحقق ما يمكن تسميته باحتفالية التلقي، وبها يتحول المسرح إلى تظاهرة شعبية، تكون قادرة على تحريك المشاعر وإثرائها بخبرات جديدة، ورؤى مختلفة.
وهنا نشير -علي سبيل المثال- إلى تجارب المسرح الاحتفالي في المغرب العربي ، تلك التي اعتمدت على الارتجال في الحوار والأداء، ووظفت المداحين والمولودية لتقديم عروض إحتفالية شعبية، ذات صبغة تميزها عن أي عروض تقليدية أخرى .. تلك التجارب لم تتطور هناك، ولم تتطور -أيضا- في مصر، على الرغم من ثراء العناصر الشعبية التي توجد في تراثنا ومنها : (الأراجوز) و (خيال الظل ) و (صندوق الدنيا و(السامر الشعبي) و(الحكواتي) . وغيرها من العناصر التي يمكن -بها- أن يكون لدينا مسرحا شعبيا، احتفاليا، يتميز بخصائص لا تتوفر لغيره من المسارح.
تلك العناصر -كلها- لها رصيد تاريخي لدى الجمهور، حين تلقاها في صغره ، وحين شاهدها ، ومن بينها – مثلا- ( الأراجوز) وهو أحد الأشكال التي اشتهرت في مصر، حتى قبل ظهور المسرح بشكله المُتعارف عليه، وكان يقدم عروضه في الأحياء الشعبية والقرى، ومازال موجودا حتى الآن في الموالد والاحتفالات الشعبية.
 ونتذكر أيضا تلك الصور المُتحركة التي يعرضها لاعب ( صندوق الدنيا ) حين يجوب القرى والنجوع، حاملا الصندوق الخشبي فوق ظهره، فيلتف من حوله الأطفال، وكذلك الكبار، ليروا عجائبه، بالصور المتلاحقة، المُصاحبة لرواية صاحب الصندوق ، الممثل والراوي – معا- يفسر للأطفال ما يرونه، ويعلق على الصور المتحركة بتعليقات تشد انتباههم .. يقدم حكاية السفيرة عزيزة، وقصة أبو زيد الهلالي، وغيرها من القصص والحكايات الشعبية.وكذلك (خيال الظل) الذي يمكن أن يصنع أشباحا وحيوانات خارقة، ونتذكر -هنا – بابات ( ابن دانيال ) وفيها قدم عددا من النصوص المُعبرة عن ذلك العنصر، والذي يرجع اسمه، ويستند إلى الخيال الذى نراه في الظلام ، حين تُسلط على أجسادنا ،أو أجزاء منها بقعة ضوء .. كل تلك العناصر والمفردات تدخل ضمن مكونات المسرح الشعبي، وتصبح الدمية -فيه- بديلا عن الممثل البشري، فيكون التمثيل – هنا – تمثيلا شعبيا غير مباشر، كما يطلقون عليه، وهو بخصائصه يكون قادرا على جذب الانتباه، وتنشيط الخيال، و ودعم التفكير والاستمتاع بالصورة..
ونتذكر أيضا تلك الصور المُتحركة التي يعرضها لاعب ( صندوق الدنيا ) حين يجوب القرى والنجوع، حاملا الصندوق الخشبي فوق ظهره، فيلتف من حوله الأطفال، وكذلك الكبار، ليروا عجائبه، بالصور المتلاحقة، المُصاحبة لرواية صاحب الصندوق ، الممثل والراوي – معا- يفسر للأطفال ما يرونه، ويعلق على الصور المتحركة بتعليقات تشد انتباههم .. يقدم حكاية السفيرة عزيزة، وقصة أبو زيد الهلالي، وغيرها من القصص والحكايات الشعبية.وكذلك (خيال الظل) الذي يمكن أن يصنع أشباحا وحيوانات خارقة، ونتذكر -هنا – بابات ( ابن دانيال ) وفيها قدم عددا من النصوص المُعبرة عن ذلك العنصر، والذي يرجع اسمه، ويستند إلى الخيال الذى نراه في الظلام ، حين تُسلط على أجسادنا ،أو أجزاء منها بقعة ضوء .. كل تلك العناصر والمفردات تدخل ضمن مكونات المسرح الشعبي، وتصبح الدمية -فيه- بديلا عن الممثل البشري، فيكون التمثيل – هنا – تمثيلا شعبيا غير مباشر، كما يطلقون عليه، وهو بخصائصه يكون قادرا على جذب الانتباه، وتنشيط الخيال، و ودعم التفكير والاستمتاع بالصورة..
كل تلك الأشكال أو المفردات الشعبية ، تكون قادرة على مخاطبة الصغير والكبير معا ، وهذا سر نجاحها ،إذا تم توظيفها بشكل جيد داخل العروض المسرحية..
والسامر الشعبي – أيضا – يُعد شكلا من أشكال ذلك المسرح ، فيه نستطيع توظيف كل تلك العناصر- السابق الإشارة إليها – ولقد لفت هذا الشكل نظر الكاتب المسرحي الرائد ( توفيق الحكيم ) حين كتب مسرحيته ( الزمار ) في عام 1930 مُستلهما فيها السامر الريفي، وبعدها كتب الصفقة في عام 1956 وحاول فيها إدخال ( الفنون الشعبية الريفية من رقص وتحطيب وغناء في إطار المسرحية ) وكانت تدور كلها في العراء أو الجرن أو أمام المصطبة ، والتفت – أيضا – إلى أهمية توظيف الحكاواتي والمقلداتي، وأحيانا المداح كما يقول، بل إنه أضاف من عنده (مقلداتية ) أي مقلدة للأدوار النسائية، وجاءت محاولاته – تلك- من أجل ترسيخ مفهوم للمسرح الشعبي، أنهاه بنص ثالث هو ( ياطالع الشجرة ).
هذا المسرح الشعبي – للأسف الشديد – ليس موجودا بشكل مؤثر، نستطيع توظيفه، في تلك السهرات الرمضانية مثلا، التي اعتاد عليها المصريون، وذلك بسبب أن معظم التجارب التي ُقدمت في هذا الإطار، جاءت فردية لاعتمادها على حماس أصحابها فقط ، ولم تتحول إلى اتجاه إبداعي نستطيع معه القول : إن لدينا مسرحا شعبيا يصلح للعرض أمام الجماهير كثيرة العدد ، وما سبق تقديمه من عروض المسرح الشعبي ، هو مجرد محاولات واجتهادات؛ ارتبطت بمواسم معينة؛ ربما كان من بينها شهر رمضان .. وتلك بدعة لا تدعمها ضرورة فنية.
وتُعد الثقافة الجماهيرية هي المكان الوحيد الذي قُدمت من خلال فرقها في الأقاليم تلك العروض التي وظفت العناصر الشعبية، لتحقيق أهداف المتعة والرسالة في ذات الوقت.. قدم ( عبد الرحمن الشافعي) بعض التجارب في هذا الميدان ، وقدم (عادل العليمي ) تجارب أخرى استندت إلى توظيف الزار بوصفه طقسا شعبيا غامضا، ومُؤثرا، ربما يعكس إيمان البعض بالخرافة، ويمارسها باقتناع شديد جدا، وهناك تجارب قُدمت داخل السرادق، بتوظيف كل خصائصه، بشكل الخيامية المتعارف عليها، هذا السرادق المستخدم في الأفراح والمآتم تم توظيفه كعنصر مكاني في بعض العروض التي قدمها ( صالح سعد )، ووظف ( بهائي الميرغني ) الأراجوز وخيال الظل في عدد من العروض التي قدمت في مسرح الثقافة الجماهيرية .. هذا المسرح تخلى- الآن- عن دوره الحقيقي، في مخاطبة الجماهير كثيرة العدد، وفي كل أقاليم مصر، تخلي عن القيام بدور المسرح الشعبي، المؤثر في الناس، والمتأثر بهم، العروض المسرحية الشعبية تحل مشكلة غياب المبنى المسرحي، لأنك تستطيع تقديمها حيث يتواجد الناس ، داخل ساحة ، أو حديقة ، أو نادي ، أو تقيم سرادقا يضم جماهير العرض المسرحي.

عبد الرحمن الشافعي
من رواد المسرح الشعبي في مصر
وعلى ذكر اسم المخرج الكبير ( عبد الرحمن الشافعي ) الذي تحمس لهذا النوع من المسرح ، وأعطاه كل اهتمام طوال حياته أذكر أنه في التاسع من سبتمبر عام 1971 أفتتح مسرح السامر على نيل العجوزة بالجيزة، وأقيم فيه مهرجان مسرح الأقاليم الذي ضم ست عشرة فرقة مسرحية قدمت عشرين عملا، وثلاث فرق للفنون الشعبية، منها فرقة الآلات والمداحين الشعبيين، التي شكلها عبد الرحمن الشافعي، وحافظ على تواجدها ونشاطها لسنوات كثيرة امتدت حتى قبل رحيله بقليل، وكان قد عُين مديرا له في ذلك التاريخ بعد نجاحه في تكوين فرقة المسرح الشعبي بالغوري عام 1967 وانتقل منها وبكل فنانيها لمسرح السامر عندما صدر قرار تعيينه كأول مدير لهذا المسرح، وفي ذلك العام أيضا قدم عرضه ( أدهم الشرقاوي ) من تأليف 🙁 نبيل فاضل ) في قصر ثقافة الغوري، وقدم عرضا آخر بعنوان ( شلبية الغازية ) للكاتب ( أمين بكير ) وفي مارس عام 1973 قدم مسرحية ( علي الزيبق ) التي كتبها ( يسري الجندي).
تلك العروض توضح بجلاء، اهتمامه المبكر – منذ بدأ مسيرة الإخراج المسرحي – بالمسرح الشعبي، حين حدد محاور ثلاثة يقوم عليها هذا المسرح :
1- موضوع شعبي يخص القطاع العريض من الشعب، يُخاطب همومهم وأحلامهم .
2- قالب بسيط لايتعالى عليهم، وإطار مفتوح يكسر كل حواجز العزلة بينه وبينهم .
3- تقاليد للفرجة الشعبية من موسيقي وأغان واستعراضات، يتم توظيفها طرفا فاعلا في العملية المسرحية دون تهميشها .
ذلك المسرح الشعبي، أهملناه لسنوات طويلة، على الرغم من أنه يُعد اللبنة الحقيقية ، لتقديم مسرح مصري خالص ، شكلا ومضمونا ، وكانت هناك بالفعل دعوات لتأكيد هذا المعنى، بحثا عن صيغة مختلفة لمسرحنا، منها كتابات (توفيق الحكيم) في هذا المجال كما ذكرت في البداية، مع تنظيره للتجربة في كتابه (قالبنا المسرحي) عام 1967 ، وفيه تحدث عن الحكواتي ، والمقلداتي ، والمقلداتية، والسامر الشعبي، ومن قبله أصدر (يوسف إدريس) بيانا بعنوان ( نحو مسرح مصري ) عام 1964 وفيه تحدث عن فكرة التمسرح والسامر الشعبي، وطبق فكرته في نص الفرافير.
والمخرج ( عبد الرحمن الشافعي ) واحد من الذين نجحوا في تقديم مسرح شعبي ، موضوعا وقالبا ، ويتجلي هذا الفهم في أعماله، ومن تصريحاته التي تبين لنا هذا الفهم قوله ( إنه علينا أن نتعامل مع الجذور، إننا نملك الإبداع المسرحي منذ وقف المداح الشعبي يردد السير والملاحم ، ويشخص أبطالها في تحاور رائع ) ولقد نجح في اعتقادي لأنه تمثل تجربة ( زكريا الحجاوي ) وهضمها، وسار في مسارها، ثم طور فيها، وذلك لأن ( زكريا الحجاوي) فهم المعادلة التي تحدد شرط النجاح في قدرة هذا المسرح على التعبير عن ( المعارك التي خاضها الشعب بحثا عن فرص المشاركة الفعلية في حياة بلده، وفي القضايا العربية على السواء، ولقد ( فهم زكريا الحجاوي هذه المعادلة البسيطة فلم يفرض أشكالا جديدة على مسرحه أو سامره، أو جوقته الجوالة التي تفرقت في السبعينيات,وأخذت الثقافة الجماهيرية بعض أجزائها لتعرضها على السياح في مصر والخارج، كأنها من الحفريات الأثرية القديمة، دون فهم حقيقي للدور الفني والثقافي الذي يفرض استمرار الوجود المُعبر عن وجدان الناس، واستمرار التطور مع أحلام الناس) راجع : فاروق خورشيد – الجذور الشعبية للمسرح العربي 1993 صفحة 168
إن الدور الفني والثقافي الحقيقي، هو الذي سيفرض استمرار الوجود المُعبر عن وجدان الناس، وبدون هذا الفهم ، ستظل المُشكلة قائمة، ولن ننجح في تقديم تلك النوعية من المسرح ، الذي هو – في حقيقة الأمر – أداة لتأصيل الهُوية ، والدفاع عنها ، حتى لاتذوب في العالم المُتغير ، الذي تسعي القوى المهيمنة فيه إلى طمس الهُويات الخاصة ، خاصة للمجتمعات ذات الحضارة والثقافة القديمة مثل مصر، وكل هذا يفعلونه بزعم أن العالم صار قرية كونية واحدة، وأن العولمة تفرض على الجميع السير في ركابها وبشروطها، التي لا تضع خصوصية ثقافتنا في حساباتها، ولذلك ينبغي أن نعلم أن تراثنا الفكري المستنير هو جزء من ثقافتنا ، ينبغي الحفاظ عليه وتوظيفه ، وتطويره في إطار الحفاظ على الهُوية .
ولقد تحدث (عبد الرحمن الشافعي) بفخر عن تجربته الأساسية في إطار ترسيخ مفهوم للمسرح الشعبي – تطبيقيا وليس نظريا – كما فعل النقاد، وتلك التجربة ضمت ثلاث مراحل على مدى عشر سنوات من عام 1984- عام 1994 تعامل – من خلالها- مع رواة السيرة الشعبية وفنانيها وحفظتها ومؤديها وشعرائها، بقصد البحث عن الظاهرة الاحتفالية المسرحية العربية المصرية، خصوصا سيرة بني هلال بعالمها الواسع العريض، المليء بالأحداث، وجاءت التجربة الأولى من 2 يناير – 7 يناير 1985 تحت عنوان ” تنويعات على فنون الأداء ” على هامش مؤتمر السيرة الشعبية بجامعة القاهرة ، بالتعاون مع مركز حضارات البحر المتوسط ، وانتهت بتقديم عرض مسرحي لمدة ثلاث ساعات، وكان عبارة عن عرض أقرب ( إلى الجلسة الشعبية التي يغلب عليها طابع العفوية، والفطرية، والتلقائية ، جلسة – كما صرح عبد الرحمن الشافعي وكتب عنها – أقرب إلى جلسات احتفالات السامر القديمة، فقدم تنويعات على فنون الأداء ، باختيار منطقة لكل راو أو شاعر أو مداح ، على أن تقدم لحظات لامعة من سيرة تحمل قيمة ثمينة، أو حدثا ذا دلالة، وإتاحة الفرصة للجميع في حدود يتم الاتفاق عليها في محاولة لخلق علاقة بين الأداء الارتجالي ، وبين حدود الفن المسرحي المُنظم ، علاقة توحد وحوار وتفاعل بين وظيفة كل منهما . وقدم العرض في مسرح مفتوح ، ثلاثي الأبعاد ، يُحلق الجمهور حول منصته من ثلاثة اتجاهات، أما البُعد الرابع فقد سقطت عنه الستائر والحواجز ، فالتحمت خشبة المسرح بالصالة ، دون حواجز.
وجاءت التجربة الثانية تحت عنوان ( من السيرة إلى المسرح ) مترجمة في نص مُستلهم من السيرة الشعبية لبني هلال، كتبه ( يسري الجندي) وصاغه في شكل من أشكال الكتابة المندرجة تحت باب الملاحم، وقُدمت تلك التجربة الملحمية في أعوام 1985 – 1986 – 1994 بعدها جاءت التجربة الثالثة تحت عنوان ( راوي السيرة منفردا ) وقدمت في دار الأوبرا المصرية عام 1991 حين استضافت عرضا شعبيا عن السيرة ضمن احتفالات شهر رمضان، ولمعالجة خصوصية المكان الذي لايتناسب مع طبيعة المسرح الشعبي، قام ( عبد الرحمن الشافعي ) بإلغاء الستارة الأمامية لخشبة المسرح ( لكسر حاجز العُزلة – كما قال – مع المشاهدين، ومدد لسانا من خشبة المسرح إلى منتصف الصالة، فأصبحت الخشبة واللسان، أشبه بمفتاح الحياة لدى الفراعنة، ثم قام بتعديل أماكن المقاعد ، فحولها من شكلها المستقيم تجاه خشبة المسرح ، إلى شكل دائري يُحيط بالخشبة واللسان معا، وعلى خشبة المسرح رُصت الدكك وكراسي المقاهي، لجلوس المشاركين من الموسيقيين أمام خلفية من أقمشة رسم عليها صور الأبطال الشعبيين ،بالإضافة إلى بعض فقرات من نصوص السيرة الشفاهية .
لقد حاولت تلك التجارب الثلاث إيجاد طريقة لإظهار الطاقة الضخمة للسيرة العربية، وحقها في أن تكون شكلا دراميا وطنيا ، متفردا ومختلفا ، عن غيرها من الأشكال الأدبية المستوردة ..

عودة مسرح السامر كمبنى بعد عشرين عاما من إغلاقه :
بعد أن ظل المبني مُغلقا لسنوات طويلة عقب زلزال 1992 ، افتتح في عام 2023 وهو حين انشيء تحت هذا الاسم، كان الهدف منه إحياء فنون الفرجة الشعبية ،واستلهامها في مسرحنا لتأكيد الهوية، تلك التي سعى لتحقيقها بعض كتاب المسرح في الستينيات، ومنهم (توفيق الحكيم) ، و(يوسف إدريس ) حين أكد على أن السامر ( لايزال مسرحا شعبيا في الريف ، لايعرف أحد متى بدأ، وفي المدينة كاد ينقرض مسرح مماثل، مسرح الحواري، وخيال الظل والأراجوز، وكل تلك الأشكال المسرحية الصريحة، ولا أعتقد أنها أشكال من احتكار الشعب المصري ولا يمنع هذا أن شعبنا بمواهبه التمثيلية والتأليفية طورها ونبغ فيها ذلك لأن الشعب المصري حدث له شيء في تاريخه لم يحدث لشعب آخر، شيء قطع تماما كل صلته بتاريخه الطويل الذي يعتبر أطول تاريخ لأي شعب معروف، أوقف تماما سريان وتوارث التقاليد الحضارية وتراكمها في وجدان الشعب وعقله الباطن والواعي ) ولهذا السبب جاءت دعوته بضرورة إحياء فنوننا تلك ، والعمل على تطويرها ، لتُصبح لنا هُوية خاصة ، مطبقا هذا المفهوم في نص وحيد له هو( الفرافير) 1964 وظل كلامه نظريا فقط ، مثله مثل ( الحكيم) ومن هنا جاءت فكرة مسرح السامر، ليكون المكان الذي يحتفي بتلك العروض المسرحية، التي تستلهم من تراثنا الشعبي ، ما يجعلها تتمتع بالخصوصية والتفرد ..
وكلمة (السامر) ذاتها تعني (الحفل الذي كان يُقام في المناسبات الخاصة سواء أكانت أفراحا أو موالد ،أو احتفالا بالختان، أو ولادة الأطفال ، أو الترفيه عن الفلاحين في ليالي الصيف،كما كان يُقام في الأعياد الدينية الشعبية والوطنية سواء في القرية أو في المدينة ) ويُعد مظهرا من المظاهر المسرحية التي تضم عددا من أشكال الفنون الشعبية ( الغناء – التحطيب – شاعر الربابة المتجول – التحبيظ ) وكلمة الشعبي التي أضيفت إليه ، جاءت على أيدي الباحثين الذي كتبوا عنه ووثقوا تجاربه في أبحاثهم الميدانية .
وتعود فكرة إنشاء المسرح كمبنى إلى الكاتب ( سعد الدين وهبه ) الذي كان رئيسا للثقافة الجماهيرية في ذلك الوقت، خاصة حين شعر أن حركة مسرح الأقاليم بلغت أوج قمتها وقدمت مهرجانا مسرحيا على المسرح القومي، وهنا أحس الرجل كما ذكر عبد الرحمن الشافعي في إحدى مقالاته ( بأنه لن تكون هناك حركة مسرحية مصرية خالصة، إلا من نتاج مسرح جاد للأقاليم، إذن لابد أن تكون هناك دار عرض في العاصمة تُطل منها ثقافة الأقاليم وفنونها على جماهير القاهرة ومثقفيها ، فكان السامر مسرحا مصريا وشعبيا خالصا ).
تم بناؤه عام 1970 في نفس المكان الموجود فيه الآن ، وافتتح 9سبتمبر قبل رحيل ( جمال عبد الناصر ) بأيام، وعُين المخرج عبد الرحمن الشافعي مديرا له عام 1971
والسؤال : لماذا عبد الرحمن الشافعي ؟
لأنه اهتم بتقديم عروض المسرح الشعبي – كما ذكرت- من خلال (فرقة الغوري) قبل إنشاء المسرح بسنوات، حين أخرج مسرحية (ياسين وبهية ) لنجيب سرور عام 1967، ومسرحية ( آه ياليل ياقمر ) لنجيب سرور أيضا عام 1968 و(كفر أيوب) من تأليف : عبد المنعم خالد عام 1969 و(أدهم الشرقاوي ) تأليف نبيل فاضل 1970 ، وكل تلك الأعمال كما نُلاحظ جاءت في إطار المسرح الشعبي، الذي انحاز له، واعتبره مشروعه الفني الكبير . حتى أنه في افتتاح المسرح، أقام مهرجانا لمسرح الأقاليم ضم ست عشرة فرقة قدمت عشرين عرضا مسرحيا ، وثلاث فرق للفنون الشعبية، منها فرقة الآلات والمداحين الشعبيين، وقدم وحده في ذلك المهرجان عرضين من إخراجه هما : (أدهم الشرقاوي ) تأليف : نبيل فاضل- و(شلبية الغازية) من تأليف أمين بكير .
وعن تلك المهمة قال ( عبد الرحمن الشافعي ) : إن المسرح لم تكن له اعتمادات مالية ( توليت مسئوليته بعد نجاحي في تكوين فرقة الحي الشعبي بالغوري عام 1967 وانتقلت منها وبكل فنانيها لمسرح السامر عندما صدر قرار تعييني كأول مدير لهذا المسرح الفقير في سبتمبر 1971 وكنا قد اعتدنا أن نعمل بدون أجر أو امكانيات انتاجية ، فقط تجمعنا روح الهُواية وحماس الفريق منهم النجار والحداد وبعض الباعة وعمال المؤسسات المختلفة، وأمين شرطة وطلبة ورئيس سنترال وسائق، هم شطار من زماننا لايملكون سوى عشقهم لفنهم ) . وبهذا العشق استمرت الفرقة ، وانضم إليها آخرون .
وتعرضَ المسرح للحريق – مع خيمة مسرح البالون والسيرك القومي – عام 1975 وظل مُغلقا إلى أن افتتحه السادات عام 1978 بعرض ( عاشق المداحين ) عن ( زكريا الحجاوي) من تأليف : يسري الجندي وأغاني :عبد العزيز عبد الظاهر ، ومن إخراج : عبد الرحمن الشافعي .
وعن هذا العرض تحديدا وملابساته ذكر ( عبد الرحمن الشافعي ) أن خبرا صغيرا نُشر بجريدة الجمهورية يوم 5 سبتمبر عام 1977 فحواه ” تمر ذكرى وفاة زكريا الحجاوي دون أن يلتفت إليها أحد ” أحيل هذا الخبر إلينا بشكل روتيني من مكتب (عبد الفتاح شفشق ) وكيل الوزارة للمراكز الثقافية ( الثقافة الجماهيرية ) باعتباري أشغل – حينها – وظيفة مدير المكتب الفني للوكالة ومديرا لفرقة الآلات الشعبية، وكما فهمت أن المطلوب كان إقامة ليلة فنية من خلال فرقة الآلات الشعبية، وهي الفرقة الممتدة من فرقة الفلاحين التي أنشأها الحجاوي عام 1957 وتم تطوير الاحتفال بعد أن كتب ( يسري الجندي ) مشروعا من ثلاث ورقات يحتوي فكرة الاعتماد على عملين من أعمال (الحجاوي ) المشهورة وهما “أيوب وسعد اليتيم “( حكايتان من الحكايات الشعبية التي كان للحجاوي الفضل الكبير في الكشف عنهما في صورتهما الأصلية ، ويستند اختيار هاتين الحكايتين بالذات إلى وجود أصول لهما في التراث الأقدم عهدا، وهي أسطورة إيزيس وأوزوريس وابنهما حورس، والتي تمثل أهمية خاصة في التراث المصري القديم والتراث الإنساني بوجه عام ) .
كل هذا النشاط الذي قدمه الشافعي لمسرح ( السامر ) منذ إنشائه، دفع باحثا وكاتبا كبيرا متخصص في هذا المجال وهو ( فاروق خورشيد ) إلى أن يكتب عن (عبد الرحمن الشافعي ) ذاكرا ( أنه لم يكتف بالعمل في ميدان المثقفين العاملين ، وإنما دخل إلى المثقفين الشعبيين، دخل إلى عمق الوجدان الشعبي عند الفنانين الشعبيين المؤدين بالصوت وبالحركة ، ومن هنا كان عبد الرحمن الشافعي موسوعة تستكمل بعد الحجاوي ومن بعد أعلاما كثيرين دخلوا الميدان من باب حقيقي، ونزلوا إلى مكان بحثا عن الصوت وبحثا عن الحركة وبحثا عن الكلمة، وبحثا عن المعنى ، إن الشافعي أضاف إلى جانب الدراسات النظرية عطاء عمليا حقيقيا ) وذكر أيضا د. عبد الحميد يونس قائلا ( إن متابعتي المتواصلة لأجهزة الثقافة الجماهيرية تجعلني مُطالبا بأن أسجل الجُهد الكبير الذي بذله (عبد الرحمن الشافعي) في فن الإخراج المسرحي وكل من يتاح له أن يتعرف على جهده يدرك أنه يجمع بين الاختيار المتميز ومالهذا الاختيار من اتصال بنفسية الجماهير، وهذا ما حرضه على تقديم مسرحيتيَ ” عاشق المداحين ” ومنين أجيب ناس “) .
وعقب زلزال عام 1992 حدثت شروخ ، تم اغلاق المسرح بسببها بزعم ترميمه، لكن الترميم لم يتم، وظل مُغلقا، بعد هدمه تماما ، لأكثر من ثلاثين عاما ، وأشهد أن المسرح لم يكن كمبنى يمثل خطورة، لو تمت معالجة الشروخ وقتها، خاصة وأن سقفه كان مجرد خيمة ، وليس اسمنتيا، ولو علم مديره في ذلك الوقت الكاتب المسرحي ( يسري الجندي) أن تسويفا سيتم طوال تلك المدة ، لتم علاج المشكلة وقتها بدون هدمه ..
المهم أنه عاد إلى الحياة من جديد بعد افتتاحه يوم الأحد 16 يوليو 2023
وبمتابعة الأعمال الأخيرة التي قدمها، وعُرضت باسمه على مسارح مختلفة، منها أرض السامر، ألاحظ أن عروضه ابتعدت كثيرا عن تلك الفكرة التي قام من أجلها، وابتعد المسرح عن الهدف الذي كان دافعا لكل من ( زكريا الحجاوي وعبد الرحمن الشافعي ) وكل من جاءوا بعدهما مؤمنين بأهمية المسرح الشعبي، وفي مقدمة هؤلاء الكاتب (محمد أبو العلا السلاموني ) الذي قدم وحده أكثر من عشرة نصوص في هذا الاتجاه، فضلا عن تنظير مهم للتجربة في كتاب أصدره قبل رحيله بعنوان ( بيان في المسرح الشعبي ) عام 2023 وأضيف إليه عددا آخر من الكتاب المُهتمين بالمسرح الشعبي (يسري الجندي – عبد الغني داود – سيد حافظ – محمد الفيل – شوقي عبد الحكيم – نجيب سرور- رأفت الدويري- بهيج إسماعيل – فاروق خورشييد – محمود دياب – الفريد فرج- محمد الفيل ) وغيرهم من كتابنا الجُدد.
إن الابتعاد عن خصوصية هذا المسرح، وتفرد عروضه، يجعل الاسم مجرد اسم، فتضيع هويته التي سعى من أجل تأكيدها كل هؤلاء ، ونصوصهم علامة تدل على جهدهم في هذا المجال ، فلا ينبغي أن نقدم فوق خشبته نصوصا أجنبية، مترجمة أو مُعدة – كما يحدث الآن- وحين نقدم نصوصا لاعلاقة لها بالفكرة التي يحتضنها المسرح، فإننا نُهدر كل المحاولات التي سعت من أجل تأكيد هوية مسرحنا المصري .
ولذلك أدعو القائمين على هذا المسرح للالتزام، بالحفاظ على المسمى ومحتواه، وليس المسمى فقط ، فلا قيمة للمسمى بعيدا عن تحقيق خصوصية ذلك النوع من المسرح الشعبي ، خاصة وأن هناك تنظيرات كثيرة كُتبت في هذا الإطار كتبها كل من ( د. علي الراعي – د. عز الدين إسماعيل – د. حسن عطية – أبو العلا السلاموني – وكاتب هذه السطور ) . تلك الكتابات ينبغي أن تساعد كتابنا في الإلمام بطبيعة الكتابة في المسرح الشعبي الذي أصبحت له أسس وقواعد، وأصبح مفهومه حاضرا ليتحقق واقعيا وفعليا في عروض يقدمها مسرح السامر .
فضلا عن أهمية هيكلة فرقة السامر المسرحية .. واختيار كوادر إدارية وفنية لإدارة المبنى نفسه، ومتابعة مشاكله وصيانته، فبدون هذا ستحدث مشكلات فنية وإدارية كثيرة ستؤثرعلى دوره .
وأخيرا : ضرورة مواصلة التجريب في هذا الإطار الشعبي ، لتتحقق الخصوصية التي تعطيه الاسم والمعنى.

أحمد عبد الرازق أبو العلا – ناقد مسرحي