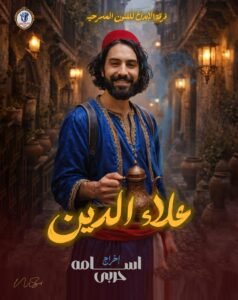د. أميرة الشوادفي تكتب: العلاقة الديالكتيكية بين التطور الاجتماعي الثوري والتطور المسرحي (المسرح المصرى نموذجا)

إن لحظات التطور المسرحي في العالم كله تنبع من لحظات التطور الاجتماعي الثوري بمفرداته السياسية والاقتصادية والثقافية في ذات الوقت فتاريخ المسرح الإغريقي يقول أن أباء التراجيديا والكوميديا ظهروا في المرحلة التي تلت المعركة الحاسمة (سلاميس) حيث انتصار اليونان على الفرس، وما أعقب ذلك من انقلاب في تركيب المجتمع الأثيني حيث زوال الأقلية الزراعية المالكة، وتقسيم الملكيات على الفلاحين المعدمين، وأيضاً جاءت المرحلة التي أنجبت شكسبير حيث انتصار الأسطول البريطاني على الأرمادا أسطول أسبانيا الذي لايقهر، لتحدث انفتاحات للآفاق أمام الإمبراطورية البريطانية، وكذلك المرحلة التي أنجبت بيتس وسينج وأوكيزي وهي المرحلة التي ارتبطت فيها الحركة الأدبية والمسرحية بالحركة السياسية التي تطالب بكسر الأغلال البريطانية التي تخنق روح أيرلندا.
مع نهاية الخمسينيات بدأت الدراما المصرية في الوصول إلى مرحلة النضج، وخاصة مع ظهور أعمال مسرحية جديدة والتي تعد فتحاً جديداً في المسرح المصري، فما بين الاستسلام للقدر الاجتماعي وبين التبشير بجيل جديد يتطلع له أبناء الوطن بدأ يسير المسرح الجديد بين التلازم والمواكبة، بين لحظات الازدهار الثوري، ولحظة الازدهار المسرحي، فبعد أن كان المسرح وقت الثورة ارهاصاً للتحول نحو الثورية الجديدة، بدأ يدخل مرحلة جديدة وهي مرحلة البحث عن الذات أو الوعي بالذات وهي في حد ذاتها تمثل مفهوماً جديداً بدأ يتطور، وبدأ يبرز معه صورة المرأة ودورانها في فلك الكتابات المسرحية، خاصة أنه على مر تاريخ الدراما لم يبق ولم يخلد إلا المسرح الإنساني، الذي يتناول قضايا الإنسان في علاقته بمجتمعه وعلاقته بأقرانه، ذلك المسرح الذي نبع من الناس وعاش معهم ولهم مثل المسرح الإغريقي، ومسرح عصر النهضة، ومسرح بومارشيه، والمسرح الأوروبي بعد الحرب العالمية الأولى والثانية.
ومسرحنا المصري عندما يتناول قضايا المجتمع بقصد النقد البناء، فهو يبحث عن الأفضل، كمسرح الستينيات بقضاياه المتنوعة، والتي تسبح في فلك القضية الأكبر والأعظم وهي القضية الاجتماعية، إذ رأى كثير من النقاد ودارسوا تاريخ المسرح أن النزعة الاجتماعية للدراما قد تأصلت بعد أبسن على يد جورج برناردوشو والذي عرف بميوله الاجتماعية واتجاهاته الإصلاحية النابعة من فلسفة الإشتراكية الفابية، والتي كان يؤمن بها ويدعو إليها، غير أن هذا الاتجاه الاجتماعي للدراما والفن المسرحي لم يكن حديثاً أو من ابتداع ابسن وشو، بل هو اتجاه كامن في الدراما نفسها باعتبارها ضميراً عاماً للمجتمع، وباعتبارها وسيلة التعبير المؤثرة التي ارتبطت بقضايا المجتمعات الإنسانية أوثق ارتباط . فالمسرح في حقيقته ظاهرة اجتماعية تتشكل وتتغير حسب طبيعة المجتمعات الإنسانية، كما أنه يتبادل التأثير والتأثر مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تطرأ على المجتمع.
فالمسرح لايمكن دراسته بمعزل عن المجتمع أو البنية الاجتماعية التي نشأ منها ولها، فالمسرح كظاهرة أدبية ينطبق عليه قول رينيه ويلك بأنه نظام اجتماعي يصطنع اللغة وسيطاً له واللغة نفسها إبداع اجتماعي، وإذ كان الأدب يمثل الحياة، فإن الحياة ذاتها حقيقة اجتماعية، والمسرح من أقدم وسائل التعبير التي ارتبطت بقضايا المجتمع منذ نشأته وعلى مدى تاريخه الطويل، وفي مختلف المجتمعات والثقافات فالدراما والمسرح هما نتاج للحياة المدنية والاستقرار حيث الميل إلى العلمانية، والعلم والأخلاق والحضارة، وظهور الآراء السياسية التي تعتمد على الإقناع لكسب مؤيدين بدلاً من السيطرة الإقطاعية.
لذلك اتسع تيار الواقعية الاجتماعية في رحلة البحث عن الذات أو الوعي بها في ذات الوقت كتيار أساسي مع بداية ظهور المسرح الحديث كتعبير عن الصراع والتناقضات القائمة داخل الطبقات، ولعل المرأة خير مثال عن هذه التناقضات منذ خمسينيات القرن الماضي، ومن الملاحظ أنها فترة مولد وتكوين محفوظ عبدالرحمن فكرياً وسياسياً ومسرحياً.

مع نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات بدأت تصعد القضية الاجتماعية على خشبة المسرح، ومعها أيضاً برزت دلالات توظيف صورة المرأة، ليتحول المسرح إلى برلمان شعبي يناقش الجمهور على خشبته قضاياه بمنتهى الدقة والوضوح والموضوعية . لذلك كسبت تلك الكوكبة جماهير الطبقة المتوسطة وهي تعد الامتداد الطبيعي للجماهير الشعبية، تلك الجماهير التي صعدت على مسرح الحياة بنفس الكيفية التي صعدت بها إلى خشبة مسرح الستينيات، بمعنى أنه قد حدث نوع من التوازي مابين الواقع الحياتي والواقع الدرامي، ترجمه الكاتب المسرحي الباحث عن ذاته، وقدمه لجمهور يسعى سعياً حثيثاً نحو الوعي بذاته أيضاً، في ظل تحولات اجتماعية طاحنة فرضت نفسها على شتى مناحي الحياة، ولذلك فالفن عموماً والمسرح خاصة ليس مرآة عاكسة لما يدور في الواقع دون إدراك للأبعاد والظروف التي تتحكم في حركة سير المجتمع، وإنما هو الضمير الواعي الذي يرى الماضي في ضوء الحاضر، ويلقي ببصره إلى آفاق المستقبل وما يمكن أن يصل إليها هذا المجتمع، لذلك لابد أن نسلم باستحالة الفصل بين الفن والمجتمع لصالح الاثنين معاً.
فالواقع يضيف للفن حسه الملموس ونبضه الحقيقي، والفن يضفي على الواقع لمسته الجمالية التي يستطيع بها المتلقي تقبل هذا الواقع، بل والعمل على تحسينه ولكن يظل هناك عبء على الفنان وهو إدراك الحد الفاصل بين دوره ودور المصلح الاجتماعي، أو الداعية السياسي والمفكر الاقتصادي، أو الواعظ الأخلاقي.
لكن الأكيد أن المسرح زادت أهميته بالنسبة لمجتمع الستينيات في مصر لدوره الملموس فهو كالبؤرة التي تتمركز فيها تجارب المجتمع وتنكشف فيها الخصائص والتحولات التي تخلق منه مجتمعاً ناضجاً متبلور يملك كل العناصر اللازمة لكيانه ووجوده.
فقد بدأ المسرح المصري في الستينيات مسرحاً تختزل فيه معاناة الإنسان وحاضره من أجل طرح رؤية مستقبلية، فهو مسرح ينطلق من جذور الواقع، مسرح يحاول أن يكون مسئولاً بالكلمة والحركة، متعدد الدلالات الأدبية والفنية المتطلعة إلى التمرد على رواسب الماضي، فقد بدأ المسرح في الستينيات إبحاراً ضد التيار المستكين المتكاسل واستحضاراً للحظة تحطم المسافة الوهمية بين العقل والمشاعر .وما بين لحظتي الإبحار والاستحضار للعقل والمشاعر بدأت القضية السياسية تدخل في منحنى مختلف إلى حد كبير عن فترة الخمسينيات، إذ لم تعد نبرة التباهي بالثورة هي النبرة الواضحة، بل بدأ وقت الحصاد أو الحساب لنتائج الثورة وأهدافها النبيلة، والمفرطة في الرومانسية الحالمة، والتي لم تتحقق بالقدر الكافي، لذا اندفع المثقف الواعي والكاتب المسرحي طارحاً العديد من الأسئلة النقدية اللاذعة، فقد ظهرت في الستينيات نصوص مسرحية نقدية تصور الواقع السياسي؛ جاءت ناقمة على السلبيات، متمثلة في غياب الحرية وانتشار الأساليب البوليسية، والإجراءات والقوانين الاستثنائية واستفحال دور أجهزة الأمن، واحتلت القضية السياسية مكان الصدارة. وحتى اللغة المستخدمة في النص المسرحي السياسي جاءت في محتوى بعيد عن المباشرة إلى حد كبير، وجاء النص مستخدماً الإبعاد الزماني والمكاني في ظل التجريد الشديد والتوظيف الماكر للرمز في أحيان كثيرة.
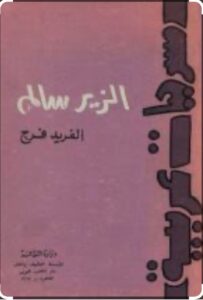
لدرجة أن الرمز يلعب دوراً فنياً ناضجاً في المسرحيات التي تتخذ المجتمع مضموناً لها، لأنه يجنبها التسطيح والمباشرة فالرمز يجسد ويركز ويكثف المعاني الاجتماعية والسياسية ويحشدها بالإيماءات المتنوعة التي تجعلنا نرى المواقف من أكثر من زاوية، والشخصية من أكثر من جانب، مما يعطي العمل ثراء وخصوصية. ومصدر هذا الثراء وتلك الخصوصية هو حرية شخصية المرأة في الكتابات المسرحية بشكل جعلها تبدو وسط دلالات متنوعة وأهداف أكثر اختلافاً.
وقد استغل المؤلف المسرحي الرمز في توظيف اسقاطاته السياسية من خلال توظيفه لبطل الكوميديا السوداء وهو أقرب النماذج وأصلحها لدراما الإسقاط السياسي حيث تصوير الحياة بما فيها من متناقضات محيرة تسعى في نفس الوقت إلى توسيع إدراك المتفرج وتمكينه من رؤية الجوانب المتعددة للأشياء حتى يراها على حقيقتها، لذلك يلجأ الكاتب إلى عرض المتناقضات جنباً إلى جنب بطريقة معينة ، حتى لو كانت المرأة هي محصلة ومحتوى هذا العرض.
لذلك غلب على دراما الستينيات طابع الكوميديا السوداء وخاصة مسرح الإسقاط السياسي، وهو أشبه بالمثل الشعبي القائل شر البلية ما يضحك، فقد أضحكنا كثيراً يوسف إدريس في الفرافير على الوضع المأسوي للعلاقة مابين السيد والمسود، والحاكم والمحكوم، في ظل عالم عبثي تقوده العشوائية، تلك العشوائية التي وصلت مداها في مسرحية عسكر وحرامية للمبدع ألفريد فرج داخل الجمعية الاستهلاكية بأشخاصها المنتقاه بعناية من قبل كاتب يعي ما يقول، خاصة اختياره للأسماء ذات الدلالات الموحية مثل (فهيم نبيه نزيه أمين – أحمد المليان – عريان – المفتش – نخلة – توفيق السالك – ميمي – زينات – المدير).
ولعل الأسماء هنا لها دلالات، فهي عبارة عن صفات في الشخصية، تزيد من عمق مأساة الشعب المصري، والذي تحول إلى لعبة أو إحدى مفردات لعبة عسكر وحرامية بمعناها الواسع والأعم، في إطار من الكوميديا السوداء، التي تعري أكثر مما تخفي، وتفضح بدلاً من أن تستر.

مسرح المواكبة والمشاركة:
تبلورت ملامح جيل كامل من كتاب المسرح في طرحهم لهموم وأفكار الزمن الجديد، من خلال النص المسرحي، متجاوزين مرحلة مسرح الانعزال، فبدأت مرحلة جديدة عرفت بمسرح المشاركة (الواقعية النقدية)، حيث التعرض لإيجابيات وسلبيات الواقع والحلم بمصر الجديدة، عبر الحرية والرخاء.
فجاءت مرحلة الستينيات قوية، فبجانب عدد كبير من كتاب الخمسينيات الذين استمروا في كتابة النصوص المسرحية، ظهر عدد جديد من الكتاب، منهم سعد الدين وهبة، وميخائيل رومان، ومحمود دياب، وصلاح عبدالصبور، وغيرهم، وبرزت على المسرح موضوعات جديدة لم تكن مطروحة من قبل، خاصة توظيف صورة المرأة بشكل مختلف ، وبدأت تيارات الصراع الطبقي تظهر واضحة وبدأ الانحياز جلياً للجديد، والذي تحمل لواءه الطبقة البرجوازية بشرائحها المتوسطة والدنيا، والمنتمون فكرياً لها، ضد القديم، والذي تمثله الشرائح المستغلة والمتعلقون بأذيالها، وتضاءل دور الصراع الأخلاقي المسطح بين الخير والشر، بين الأبيض والأسود، ليصبح في خلفية الصراعات الاجتماعية والاقتصادية، ولم يعد انتصار الخير قائماً على قيم غيبية، وإنما بدأ البحث على ضرورة تحقيق انتصارات تعتمد على القيم العلمية والموضوعية. ولم يكن الواقع السياسي منفصلاً عن واقع المسرح، إذ أنه ولم يكن المسرح بعيداً عن هذه الأجواء، إذ كانت حركة المسرح على علاقة وثيقة بحركة المجتمع، وبالفعل ازدهرت الحركة المسرحية، وخاصة أن السلطة وجدت في المسرح لعبة لإلهاء المفكرين والأدباء، كما أنها أرادت جس نبض اتجاهات وآراء المفكرين والجماهير عبر الكتابة المسرحية، لذلك وظف الكاتب نصه المسرحي لبلورة الرؤية المصرية، فكان التخلي عن اللغة الفصحى كأداة للتعبير المسرحي واستخدام العامية، والتي تشكل لغة التفكير والإحساس لدى الإنسان المصري، أما العامل الثاني الذي ساعد جيل الستينيات من الكتاب على احتضان الروح المصرية وتصويرها والتعبير عنها فكان الاعتناق إلى درجة الإسراف في التصوير الواقعي في كثير من الأحيان خاصة في عرض صورة المرأة في شكلها المتدني بطريقة فجة إلى حد كبير.

لذلك نرى أنه قد نما في تلك الفترة اتجاهان ي الكتابة المسرحية: الاتجاه الأول قديم وله امتداد، ويتمثل في مسرح المواكبة للأحداث والسير في الركب. أما الاتجاه الثاني، فهو مسرح المشاركة ذو الأهداف الواضحة. وكانت مشكلة الفصحى والعامية هي إحدى سمات مسرح الستينيات، لدرجة أن كثر الجدل حول هذه القضية مابين مؤيد ومعارض، كما ثار جدل آخر حول القديم والحديث، والشكل المضمون، وهي قضايا نقدية مطاطية مازالت آثارها القديمة موجودة إلى الآن، فبرزت كتابات الواقعية النقدية، والاقتراب من المسرح الملحمي في فترة كانت في أمس الحاجة إلى مثل تلك الكتابات لحث الجماهير نحو التغيير. لذلك تبنى العديد من الكتاب الأسلوب البريختي الملحمي، وتجلى هذا الأسلوب في كتابات ألفريد فرج – محمود دياب – يوسف إدريس – ميخائيل رومان – رشاد رشدي – ويسري الجندي وكذلك أبوالعلا السلاموني وبهيج إسماعيل، وغيرهم، كما تأثر المسرح المصري في الستينيات بالتيارات الفكرية والمدارس الفنية الوافدة، ومن هذه المؤثرات التي ظهرت بشكل واضح المسرح الملحمي، فالتيار التعليمي الملحمي كان في ذلك الوقت هو التيار الموضوعي العقلاني السياسي والاقتصادي المتصل بحركة التغيير الثوري المطروحة في مصر. ولذا تأثر العديد من الكتاب بالمسرح البريختي أمثال نجيب سرور، وعبدالرحمن الشرقاوي، وألفريد فرج، ونبيل بدران، وغيرهم، وكان هذا التأثر بدرجات متفاوتة، فمنهم من تأثر به من ناحية المضمون فقط، ومنهم من تأثر به من ناحية الشكل فحسب، وهناك من جمع في تأثره مابين الشكل والمضمون، حتى في الطرح البريختي لتيمة المرأة.